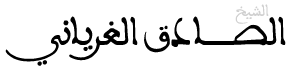بسم الله الرحمن الرحيم
بيع المرابحة للآمر بالشراء - الذي شاعَ في المصارف الإسلامية، وفي غير المصارف الإسلامية أيضا ـ يقومُ على أنْ يأتي المستفيد إلى المصرفِ يريد شراء سلعة؛ بيت أو مصنع أو سيارة، يكون قد عاينها، أو علِمَ أوصافَها، واتفقَ مع البائعِ على ثمنها، فيقدم المستفيدُ أوراقَها إلى المصرفِ، راغبًا في أنْ يشتريَها المصرفُ ويبيعَها له، فيشتري المصرفُ السلعة لنفسِه، بعد الدراسةِ والتحققِ من جدواها، بناءً على وعدِ المستفيد بشرائِها منه، ويبيعُها له بربحٍ محددٍ، مع تقسيطِ الثمن.
ثمّ إن بعضَ المصارف جعلتِ الواعدَ بالشراءِ مُلزَما بالشراءِ؛ بناءً على وعدِه، ولا خيارَ له، وإذا تأخرَ فإنّ مِن حق المصرفِ أن يُلزمه بتعويضِ ما يقعُ عليه مِن الضرر، حتى إنّ مِن المصارفِ من يأخذُ من الواعدِ بالشراء مالًا مُقَدَّمًا عند الوعدِ، يُسمونَه (هامش جِدِّية)، يُخصم منه الضررُ عندَ الترك.
وأكثر المصارف الإسلامية تأخذُ بهذا الاتجاهِ في الإلزامِ بالوعد، وبعضُها ـ مثل بيت التمويل الكويتي، ومصرف الراجحي، ومصارف السودان ـ لا تأخذُ بالإلزام بالوعد، وتعطِي للواعدِ الخيارَ بعد تملكِ المصرف للسلعة، إن رغبَ اشترى أو تَرَكَ.
وصدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليّ رقم 40 في المسألة، فمنَعَ المواعدةَ الملزمة من الطرفينِ، وجعلها في قوة العقدِ المؤدِّي إلى بيع السلعة قبل تملكِها، الوارد فيه النهي، وجعلَ الوعد الملزم من طرفٍ واحدٍ جائزًا، رفعًا للضرر المترتبِ على الترك، ولم يجعله في قوةِ العقد؛ كما في المواعدة.
والعلماء المعاصرون اختلفوا؛ فمنهم من جوَّزَ الوعدَ المُلزِم، ومنهم مَن منعه، وجعله في قوةِ بيع الشيءِ قبل تملكه.
والذي دعاني إلى الكتابة في الموضوعِ، مع كثرةِ مَن كتب فيه مِن الفضلاءِ مِن أهل العلم؛ أنّ المجيزين للإلزام بالوعدِ، يقولونَ إنّ مستندَهم في الجوازِ أمورٌ ثلاثة:
1ـ المذهب المالكيّ، القائل بوجوبِ الوفاءِ بالوعد.
2ـ أن المالكية جوزُوا المواعدةَ الملزمة على الصرفِ، مع ما يترتبُ عليها من التأخير في عِوضي الصرفِ، قالوا: وهذا يؤكدُ أن مذهب المالكية هو الإلزامُ بالوعدِ في عقودِ المعاوضات أيضًا، لا خصوص العِدَة والتبرعاتِ.
3ـ العمل بالمصلحة، وذلك بعد أن ساءَ حالُ الناس في التعامل، فقد يَعِد التاجرُ المصرفَ بشراء سلعةٍ تُكَلِّفه مئات الملايين، ولا يشتريها منه، والمصرفُ لا يجد لها سوقًا، فتتعرض أموالُ الناس للضياع.
حكم الوعدِ بشراء السلعةِ، كما جاءَ في كتب السنة:
جاء في حديث حكيم بن حزام، الذي خرجه أحمد والأربعة والبيهقي في السنن قال: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ، فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِن البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِن السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) .
وحديث حكيم هذا يُعد نصًّا في مسألة الوعد، فقد قال حكيم للنبي صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ بعد أن يأتيه الرجل يسأله البيع: (أبتاع مِن السوقِ ثم أبيعه)، وثم تفيد الترتيب الزمني، كما هو معروف، يعني: أنّ البيع للرجل حصل بعد ابتياع حكيم من السوق، وهذا ظاهره السلامة؛ لأنه بيعٌ بعد التملك، إذ لم يقل حكيم: أبيع ثم أبتاعُ من السوق، بل قال: أبتاعُ من السوق ثم أبيع، فما حصل من حكيم بن حزام والرجل ليس إلا وعدًا بالشراء قبل التملك، وليس عقدًا للبيع قبل التملك، ونهاه النبي صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ عنه، وأدخله في بيع ما ليس عنده.
وكذلك قول ابن عمر هو نص في المسألة أيضًا، ولفظه كما في الموطأ: أن يأتيَ الرجل إلى آخر ويقولُ له: "اشترِ كذا وكذا، وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا"، فقال له ابن عمر: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" .
تحقيق قول المالكية في الوعد بشراء السلعة قبل تملكها:
جاء في الموطأ عن مالك: "أنّه بلغه أنّ رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعيرَ بنقدٍ حتى أبتاعَه منك إلى أجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر؛ فكرهه، ونهى عنه" .
وفي البيان والتحصيل، قال ابن رشد وهو يُعدِّد صور بيع العينة: "الثانية أن يقول له ـ أي مريدُ الشراءِ للبائع ـ : اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، قال: فهذا لا يجوز" ، وقال في المقدمات: "الخامسة: وهي أن يقول اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، فهو أيضا لا يجوز" .
وقال القاضي عياض في التنبيهات: "الحرام الذي هو ربا صُراح؛ أن يُراوض الرجل الرجلَ على ثمن السلعة، يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل، ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا، أو يُراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره، فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا، ابن حبيب: هذا حرام" .
وسواء قال الآمر بالشراء للمأمور (المصرف أو غيره): اشتر لي بكذا وأنا أربحك دينارين، أو قال: اشتر وأنا أشتري منك، ولم يقل (لي(.
والمنع في الصورة الأولى (اشتر لي) مقيد بما إذا كان النقد من المأمور مشروطًا عليه؛ لما فيه من اجتماع السلف والإجارة، لأنه استأجره بدينارين على أن يشتري له السلعة وينقد عنه، ولأنه أسلفه ثمن البضاعة ورجعه إليه بزيادة الربح ، قال الخَرَشي: "لا يجوز، لما فيه من سلف جر نفعا" ، وقال الحطاب، ناقلا عن ابن رشد في البيان والمقدمات: "فذلك حرام؛ لا يحل ولا يجوز، لأنه من رجل ازداد في سلفه، فإن وقع لزمت السلعة الآمر (العميل)؛ لأن الشراء كان له، وإنما أسلفه المأمور ثمنا ليأخذ أكثر منه إلى أجل، فيعطيه العشرة معجَّلة ويطرح عنه ما أرْبَى" ، وقال الخرشي: "ويُلزَم الآمر (العميل) بالعشرة، ويُفسخ البيع الثاني باثني عشر إلى أجل" .
ووجه المنع في الصورة الثانية، صورة ما إذا قال: اشتر، وأنا اشتريها منك، ولم يقل (اشتر لي)، أمران:
1 ـ بيع المأمور السلعة قبل ملكها؛ لأنه يجعل الوعد من العميل بالشراء لازمًا، لا انفكاك له منه، قال ابن رشد: "لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور، فدخله بيع ما ليس عندك" ، وقد نهى ابن عمر "أن يأتي الرجل إلى آخر ويقول له: اشتر كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا، وقال له: لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" .
2 ـ القصد إلى العينة، لأن المأمور (المصرف) لا غرض له في السلعة، ولا هو يريدها، وإنما يريد العين، وذلك باستبدال عشرة عاجلة باثني عشر مؤجَّلة.
ولا يُعكِّر على ما تقدم من المنع في الصورة الثانية، قول ابن رشد في (البيان): "اختلف فيه إذا وقع على قولين؛ أحدهما أن السلعة لازمة للآمر باثني عشر إلى أجل؛ لأن المأمور كان ضامنا لها لو تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمر، ويُستحب له أن يتورع، فلا يأخذ منه إلا ما نقد فيها، وهو قول ابن القاسم ... وروايته عن مالك، والثاني أن البيع يُفسخ وتُرَدُّ السلعة إلى المأمور ... كما يفعل بالبيع الحرام؛ لأنه باعه إياها قبل أن تجب له، فيدخله بيع ما ليس عندك" .
هذا القول الذي ذكره ابن رشد في (البيان)، هكذا مطلقا؛ بإمضاء البيع إذا وقع في أحد القولين، لا يتعارض مع ما تقدم من النقول، عن ابن رشد والقاضي عياض والحطاب والخرشي بالمنع؛ لأنه محمول على ما قيده به ابن رشد في المقدمات، من أنه مشروطٌ بإعطاء الخيار للطرفين، في إمضاء البيع الثاني وتركه، وليس عليهما فيه إلزام، حيث قال في المقدمات عند ذكر المسألة؛ كما ساقها في البيان بنصها: "ولو أراد ألاَّ يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له" ، فإنه يدل على أن قول ابن القاسم بإمضاء البيع إذا وقع مبنيٌّ على أن الوعد بالشراء من الآمر غير مُلزِم، وما دام غير ملزم له فمعناه أنه على الخيار، إن شاء مضَى في الصفقة، وإن شاء تركَ، والخيار لا يبقى معه المحذور الذي مِن أجله كان المنع، وهو بيع المأمور السلعة قبل تملكها.
فقول ابن القاسم المروي عن مالك بإمضاء البيع إن وقع، مُقَيَّد في المقدمات، وكذلك عند شراح خليل بقيدين:
1 ـ أن يكون ضمان السلعة ـ قبل أن يشتريها الآمر (العميل) ـ من المأمور (المصرف)، بأن يشتريها بالفعل ويتحمل تبعاتها.
2 ـ أن الآمر (العميل) يثبت له الخيار بعد دخول السلعة في ملك البائع، ولا يُجبَر على أخذها إن أَبَى.
وعلى تقييد إمضاء البيع بهذين القيدين قرَّر الحطاب كلام خليل، فقد ذكر الحطاب هذين القيدين، ثم قال مستدركا على خليل عدم ذكره إياهما، ومعتذرا له في الوقت نفسه، قال: "ولم يُنَبِّه المصنف على ... أن ضمان السلعة قبل أن يشتريها الآمر من المأمور، وعلى أن الآمر لا يلزمه أن يأخذ السلعة إن أبى، لوضوح ذلك" .
وعلى تقييد الجواز بكون العقد على الخيار، قرر البناني أيضا كلام خليل، حيث قال: "وبالجملة فضمان المأمور ـ أي للسلعة ـ وكون الخيار له وللآمر في العقد؛ إنما هو قَبْل وقوع البيع الثاني" .
هذا هو مذهب المالكية في مسألة الوعد الملزم، وبابها في كتبهم: باب العينة وبيوع الآجال من كتاب البيوع.
وما نقل عنهم مما يخالف هذا من القول بصحة الوعد الملزم في المرابحة - بحجة أن الوفاء بالوعد عند المالكية واجب ـ هو من البُعد في التخريج، إذ ليس الوفاء بالوعد الذي يقول به المالكية من هذه المسألة ـ أي: مسألة المرابحة ـ في صَدر ولا وِرْد، فمحله عندهم التبرعات إذا أدخل الموعود نفسه في التزام يُثقله بسبب الوعد ، فالاستدلال بكلام المالكية في الوفاء بالوعد على جواز جعل الوعد ملزما في عقد المرابحة للآمر بالشراء، من الاستدلال بالكلام في غير موضعه، وخارج سياقه، إذ الأول محله في كتبهم باب العِدَة والتبرعات، والثاني محله بيوع العينة والآجال، وقطع الكلام عن سياقه يفسد معناه، فهو كمن يقرأ: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ)، أو (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ) ويسكت.
والوعد في هذه المسألة بخصوصها، تعرض له المالكية في باب العينة وبيوع الآجال، ونصوا على تحريمه، بل هم من أكثر الناس تشددًا فيه، كما تقدم النقل عن القاضي عياض بأنه ربًا صُراح ، فكيف يُجعل مذهبُهم مُستَندًا للجواز؟! والرواية القائلة بإمضائه بعد وقوعه محمولة على ما إذا كان الواعد بالخيار، كما تقدم عن المقدمات والحطاب والبناني
.
المواعدة على الصرف التي يقول بها المالكية:
من الباحثين الفضلاء في هذه المسألة، من استند في القول بالإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، إلى أحد قولي المالكية ـ غير المشهور؛ كما يأتي ـ بجواز المواعدة في الصرف على صورتها الملزمة، مع ما يترتب عليها من التأخير في عوضي الصرف، قالوا: وهذا يدل على أن الإلزام بالوعد هو مذهب المالكية، ليس فقط في العِدة والتبرعات، بل في البيوع والمعاوضات؛ لأنّ الصرف بابه بابُ المعاوضات، فهو بيع من البيوع، وقد ذكرت كتبهم الاختلاف في جواز هذه المواعدة على صورتِها الملزمة، فتكون قاعدة في الباب عندهم.
فما حقيقة هذا الاختلاف المشار إليه في المواعدة على الصرف، التي انفردَ بها المالكيةُ، وما الأساس الذي بُني عليه الاختلاف، وهل هو اختلاف حقيقيٌّ؛ بالمنع والجواز على التضاد في الأقوال؟ أم هو اختلاف تنوع، ينتهي عند التحقيق إلى قولٍ واحد، يرجع فيه اختلاف الأقوالِ إلى اختلاف الأحوال، ولا اختلاف حقيقة؟
صورة المواعدة على الصرف:
المواعدة على الصرف؛ كما جاءت في كتب المالكية: أن يقولَ شخصٌ لآخر: آتيك غدًا لأصرف عندك كذا وكذا، ويتفقانِ على الثمنِ، ويجعلان ذلك عقدًا يلتزمان به، ولا يستأنفان عقدًا جديدًا مِن الغد، القول المشهور الذي شهره ابن الحاجب وابن عبد السلام؛ أنّ المواعدة على الصرف بهذا المعنى حرام، وبه قال أصبغ، وقال ابن رشد: هو ظاهر المدونة، وذلك للتأخير الحاصل في قبض عوضَي الصرف.
وشهر المازري الكراهة، ونسبه اللخمي لابن القاسم ومالك، وعلى القول الأول يفسخ الصرف إذا وقع، ويُرَد، وعلى القول الثاني ـ قول ابن القاسم ـ يمضي بعد الوقوع، ولا يُرد، ولابن نافع قول ثالث بالجواز، ذكر ذلك كلّه الحطاب في مواهب الجليل، وعزاه إلى مقدمات ابن رشد وغيرها .
ووَجَّه ابن رشد هذا الخلاف توجيهًا يتفق وينضبط مع ما هو مقرر في الفقه المالكيِّ، في مسألة المواعدة على العقود، مفاده أن قول ابن القاسم بالكراهة، وقول ابن نافع بالجواز؛ مبنيانِ على حالة ما إذا لم يكن في الوعد بالصرف عقد ولا إلزامٌ، وقول أصبغ بالمنع؛ مبنيٌّ على ما إذا جعل العاقدان الوعد ملزمًا لهما، بأن جعلاه عقدًا لا يُنشئان معه عند وقوع الصرف عقدا آخر، أو جعلاه ملزما في قوة العقدِ، بأن تساومَا وتراوضَا وقتَ المواعدة، ولو لم يجعلاه في ذاته عقدًا، قال ابن رشد في المقدمات، بعد أن أورد الأقوال موجها لها: "ولعل قول ابن القاسم ـ أي بالكراهة ـ إذا لم يتراوضا على السوم، وإنما قال له: اذهب معي أصرف منك، وقول أصبغ ـ أي بالمنع ـ إذا راوضه" .
والمراوضة معناها: الاتفاق عند المواعدة على الصرف على سعر الصرف، بأن يقول أحدهما للآخر: اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا، ويسمي الثمن، وعدم المراوضة: المواعدة التي لا يحصل معها ذكر للسوم، وإنما يقول أحدهما للآخر: اذهب معي أصرف منك ذهبك.
وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن الوعد على الصرف مع المراوضة، فقال: لا خير فيه، ففي المدونة: "... فلو قال له إن معي دراهم، فقال له المبتاع: اذهب بنا إلى السوق حتى نزنها، ثم نراها وننظر إلى وجوهها، فإن كانت جيادًا أخذتها منك؛ كذا وكذا درهمًا بدينار، قال: لا خير في هذا أيضًا، ولكن يسير معه على غير موعد، فإن أعجبَه شيء أخذَ، وإلا تَركَ" .
وعدم ذكر السوم والمراوضة، هو ما سماه ابن مَنَاس : التعريض دون التصريح، كالتعريض بالخطبة في النكاح في العِدَّة، وأشار إليه خليل في التوضيح بقوله: وأجازه ـ أي أبو موسى ابن مناس ـ على هذه الصورة؛ أي: صورة التعريض، التي ليست فيها مراوضة على السوم.
وعندما ذكر شراح خليل الصورة المحرمة في المواعدة، وصوروها بقولهم كما في الشرح الكبير وغيره: "بأن جعلاها عقدًا لا يأتنفان غيره" ، نبهوا على أنّ ذلك لا يدل على أنّ المواعدة تجوز مع ائتناف العقد، حتى مع التراوضِ على السوم، بل الجواز مقيدٌ بما إذا لم يتراوضا عند المواعدةِ على السوم، وإلا - بأنْ تراوضا - كانت المواعدة ممنوعة، ولو جدّدَا العقد بعد ذلك.
يدلّ لهذا تقييد الدسوقي كلام الدردير، فعندما ذكر الدردير الصورة الجائزة للمواعدة بقوله، وهي: "أن يقول أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى السوق للصرف، فيذهب معه الآخر، ثم يجددان عقدا بعد النقد، فهذا جائز"، قال الدسوقي: "وقوله: (فيذهب معه) أي: من غير أن يتفقا على أن يأخذ منه قدر كذا في مقابلة كل دينار" .
فقد قيد الدسوقي صحة المواعدة المصحوبة بتجديد العقد؛ بألّا يتفقا على أن يأخذَ منه قدر كذا في مقابلة كلّ دينار، أي: لم يتراوضا على السوم، وهذا بَيِّن الدلالة في أن مَدار الحِلِّ على عدم وجود المراوضة على السومِ قبل الصرف، لا على تجديدِ العقد وحده، فإن تجديد العقد مع المراوضة على السوم وقت الوعدِ؛ لا يُخرج المسألة من الحرمة إلى الجوازِ، وهو ما يتفق تمامًا في الفقه المالكي مع ما ضبطوا به المواعدةَ على بيع الشيءِ قبل تملكه، فإنهم أجازوها مع الكراهةِ إذا لم تكن هناك مراوضةٌ على السوم، ومنعوها مع ذكرِ السوم مطلقًا، وأدخلوها في بيعِ ما ليس في ملكِ بائعِه.
قال ابن رشد في المقدمات: "والمكروهة أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا، فأنا أربحك فيها، وأشتريها منك، من غير أن يراوضه على الربح، والمحظور أنْ يراوضه على الربح، فيقول: اشتر سلعة كذا بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها، وأبتاعها منك بكذا، ونحوه" ، وتقدم كلام القاضي عياض في التنبيهات: "الحرام الذي هو ربا صراح؛ أن يُراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي يساومُه فيها؛ ليبيعها منه إلى أجل، ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدًا، أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره، فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا، أو للعشرة كذا، ابن حبيب: هذا حرام" .
يُستفاد من هذا؛ أن الوعد على الصرف، وعلى بيع الشيء قبل ملكه عند المالكية، حكمه واحد، إن كان بمراوضة وذكرٍ للسوم كان ممنوعا بالاتفاق، وهو ما وجه به ابن رشد روايات المواعدة على الصرف، ودل عليه تصريحهم به في المواعدة على بيع الشيء قبل تملكه، مبسوطًا في كتبهم؛ عند ابن رشد والقاضي عياض وشراح خليل، على وجه بَيِّن، لا خفاء فيه ولا احتمال.
وبهذا يتبين عند التحقيق؛ أنّ المالكية لا تختلف عندهم المواعدة على الصرف عن الوعد ببيع ما ليس عند بائعه في المرابحةِ، وأنه إذا حصل في الوعد مراوضة على السوم واتفاق قبل التعاقد، امتنع الوعد في كليهما؛ في بيع المرابحةِ لدخوله عندهم في بيع ما ليس عند بائعه، وفي الصرفِ لمَا يترتب عليه من الصرف المؤخر؛ لأنهم جعلوا المواعدة على الصرف مع المراوضة على السوم، في قوة العقد قبل التقابض في عوضَي الصرف، كما جعلوا المواعدة على بيع ما ليس عند بائعه مع السوم، في معنى بيع الإنسان ما لا يملك؛ كما صرح به حديث حكيم بن حزام.
وتتبع كلامهم في مسألة الوعد؛ يدل على أن الحد الفاصل بين الجواز والمنع هو الخيار أو الإلزام، وأن مَدار التفريق بين الوعد الجائز من غيره - في الصرف وفي المرابحة ـ قائم على ذلك، فمتى كان في الوعد خيار جاز، ومتى كان فيه إلزام امتنع، وهذا مطرد لا ينخرم عندهم، حتى إنهم قالوا: "ليس من الممنوع في الصرف أن يشتري شخص الحلي من الذهب بالنقد على أن يريَه لأهله، فإن أعجبهم رجع وأتمّ البيع، وإن لم يعجبهم رده" ، فهذا وعد بالصرف، لكنه لما كان وعدًا ـ لا عقدًا ـ وكان على الخيار، ينشأ عنه عند اختيار الإمضاء عقد جديدٌ؛ أجازوه.
وبذلك لا نستطيع أن نجد للقول بالوعد الملزم في المعاوضات عند المالكية أساسا في فقههم، يمكن الاستناد إليه، ويبقى الإلزام بالوعد الذي يقولون به بابُه العِدَة والتبرعات، لا المعاوضات، وحَدُّه كما ذكره الحطاب: "العدة ـ كما قال ابن عرفة ـ إخبار عن إنشاء المخبر، معروفًا في المستقبل" ، فقيدوها بالإخبار بالمعروف، لا بما هو عقد معاوضة.
مذهب الحنفية والحنابلة في الإلزام بالوعد:
لم يتعرض الحنفية ولا الحنابلة في كتبهم بالتفصيل لبيع المرابحةِ للآمر بالشراء، لكنهم ذكروا في كتبهم ما يدل على أنهم لا يجيزون الوعد الملزم بشراءِ سلعة قبلَ تملكها، ولذا؛ لما افترضوا المسألة على الصورة التي تجريها المصارف، وذكروا أن الآمر قد يبدو له عدم الشراء فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، فكيف الحيلة في ذلك؟ لم يقولوا: الحيلة في ذلك أن نلزمه بالوعد، ونأخذ منه (هامش جِدِّية)، يرفع به الضرر عن المأمور، بل أرشدوا المأمور إلى حيلة يحمي بها نفسه، ويخرج بها من المأزق، وهي أن يشتري هو أيضا ـ أي المأمور ـ على الخيار، فيرتفع عنه الضرر برد السلعة إن تركَ الآمر، فهذا يدل على أن خيار الآمر في وعده شيء مقرر لديهم، لا يصح العقد إلا به، ولو كان يصح إلزامه بوعده عندهم؛ لَمَا التجئوا إلى حيلة خيار البائع مع بائعه.
قال محمد بن الحسن في كتاب الحيل: "قلت: أرأيت رجلا أمر رجلًا أن يشتري دارًا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها؛ فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟
قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، ويقبضها، ويجيء الآمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم، فيقول المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازمًا، ويكون إيجابا من المأمور للمشتري: أي: ولا يقول المأمور مبتدئا: بعتك إياها بألف ومائة؛ لأن خياره يسقط بذلك، فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه، وإن لم يرغب الآمر في شرائها، تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيُدفع عنه الضررُ بذلك" .
وكذلك فعل ابن القيم في إعلام الموقعين، فقد أشار إلى المسألة بعينها وهو يمثل للحيل الجائزة، فقال: "رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد.
فالحيلة: أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار .
مذهب الشافعية:
ذكر الشافعية بيع المرابحة للآمر بالشراء في كتبهم تفصيلا؛ كما ذكرها المالكية، لكن الجواز عند الشافعي مُقيَّد بما قيده به المالكية، وهو أن يكون المشتري الذي وعد بالشراء بالخيار بعد إحضار السلعة، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فوعده غير مُلزِم عند الشافعية، ولا يُعد عقدا، فله أن يتركه، وإذا أراد المشتري إتمام البيع عندهم، فلا بد له مِن تجديدِ عقدٍ جديدٍ بعد تملك البائع للسلعة.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: "وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: (أربحك فيها) بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعًا, وإن شاء تركَه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا، ووصفه له، أو متاعا ـ أيَّ متاعٍ شئت ـ وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى مِن نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه وأشتريه منك بنقد، أو دين، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر, فإن جَدَّداه جاز, وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخ من قبل شيئين:
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا" .
وبذلك يتبين أن الخيار في الوعد هو شرط لصحة العقد بالاتفاق، عند فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولم يخالف فيه أحد، وأنّ الوعد المُلزِم دون خيار منهيّ عنه، مُفسِدٌ للعقد عندهم، وهو ما دل عليه صريحُ حديث حكيم بن حزام المتقدم، وحديث ابن عمر رضي الله عنهم.
وكانت صحة العقد مع الخيار محل اتفاق، لأن الخيار ينشأ عنه عند اختيار الإمضاء عقد جديد، حاصل بعد تملك السلعة، وهذا لا يخالف فيه أحدٌ، لارتفاع المحذور، وحصول بيع حقيقي بعد التملك، فآل قول الأمة جميعا في مسألة الوعد في بيع المرابحة إلى معنى واحد، وقول واحد، موافق لما دل عليه حديث حكيم بن حزام .
وقد حاولت الفتاوى أن توجِد فرقًا بين المذهب الشافعي وغيره، في مسألة الإلزام بالوعد، وعندي أن الخلاف بين المذهب الشافعي وغيره لفظيٌّ، لا ينتج عنه عند التحقيق أي فرق في الحكم؛ لأن الشافعي عندما جوز، جعل الواعد الذي وعد بالشراء في حِلٍّ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فوعده بالشراء غير مُلزِم، وهذا هو الفارق الذي اختلف بسببه الحُكم بين الشافعية الذين أجازوا، وغيرهم الذين منعوا في المسألة، فإنّ عدم إلزام الواعد بالشراء يجعل التهمة بالتحايل على الربا ضعيفةً جدا، أو معدومة، إذ التخيير يجعل التواطؤ السابق مع المشتري على شراء السلعة قبل تملكها في حكم العدم؛ لأن الآمر بالشراء بعد تملك المصرف للسلعة يُنشئُ مع المأمور عقدًا حقيقيا بالشراء بالثمن الآجل، مختارا فيه، قد يُنشئُه معه، وقد ينشئه مع غيره، فلو أنشأه مع غيره لا يُختلف في جوازِه، فإنشاؤه مع المأمور كذلك، لا ينبغي أن يُختلف في جوازه، ولذا عندما ذكر المالكية القول بإمضاء العقد إذا وقع، قَيَّدوه بما إذا كان البيع واقعا على الخيار، وليس فيه إلزام بعد إحضار السلعة؛ كما تقدم في توجيه ابن رشد لقول ابن القاسم.
وعندما بحث علماء الأحناف والحنابلة عن مخرج من الضرر الذي قد يلحق المأمور، بسبب ترك الآمر لوعده، قالوا: الحيلة أن يشتري هو (أي المأمور) أيضًا على الخيار، فآل القول عند الشافعية وغيرهم إلى قول واحد، هو اشتراط الخيار في صحة العقد، وبطلانه مع عدمه" .
لذا؛ فكم أتمنى أن ترجع جميع المصارف الإسلامية إلى هذا القول الواحد في عقود المرابحة، وتعطي الخيار للمشتري؛ حتى يَصِحَّ العقد، ولا يُخالفَ النهي الوارد في السنة.
ولا يَرْفَعُ الإشكالَ عندي تجديد عقد الشراء من قِبل المشتري بعد إحضار السلعة، ما دام الوعد مُلزِما ابتداء، لا يُعطي للمشتري خيارا؛ لأن تجديد العقد مع بقاء الإلزام لا يعدو أن يكون إجراء شكليا للوصول إلى العِينة، حيث إن الإلزام قائم بدونه، والنية متجهة إليه، مُبَيّتةٌ عليه، وكذلك التفريق بين الوعد والمواعدة، بتجويز الوعد ومنع المواعدة، لا يظهر له أي فرق جوهري، يغير من حكم المسألة؛ لأن إلزام البائع بالوفاء هو تحصيل حاصل، لا يُحتاج إلى اشتراطه عليه، لرغبته فيه؛ يدعوه إليه الطبع، والحرص على التخلص من السلعة، وضمان الربح، وحرصه على التخلص من السلعة، هو الذي جعله يلزم المشتري بضمان الجدية، حتى لا يخل بوعده، ويورطه فيها، فإلزام البائع بوعده بأن يبيع، لا معنى له، ولا فائدة منه، وهو كمَن يلزم الجائع ليأكل.
ولذلك؛ عندما تكلم الفقهاء على المسألة كالإمام الشافعي - وقالوا لو كانت على الخيار لجاز - إنما ذكروا خيار المشتري، وليس خيار البائع، قال الشافعي: (والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا, وإن شاء تركه)؛ لأن إعطاء الخيار للمشتري بعد إحضار السلعة، يُعطي للتعاقد الجديد حقيقة العقد على شراء السلعة، بعد تملك البائع لها.
لذا؛ فكم أتمنى مرة ثانية، أن يُعاد النظر في القرارات الصادرة من المجامع والمجالس الفقهيةِ، في الوعد بالمرابحةِ، بحيث تُعطِي قراراتُها فروقًا حقيقية بين الصور المُطَبَّقة للمرابحة في المصارف الإسلامية، وبين بيع ما ليس في ملكِ بائعه، الذي جاء النهي عنه في السنة.
ولما كانت قوانين المصارف التقليدية لا تُبيح لها التجارةَ وتَمَلُّكَ السلع، الذي أحلّه الله تعالى في البيع والشراء، وتبيح لها العينة، وبيع النقد بالنقد متفاضلًا، وجدَتْ في الإلزام بالوعد في المرابحة ضالتَها، حيث حققت لها بالإلزام بالوعدِ ما كانت تتوصلُ إليه مِن الإقراضِ بفائدة مضمونة، في صورة البيع، دون تحمل مخاطرِ احتمالِ الغُرم، الذي هو أساس العقود في حِلِّيَة الربح والغنم.
التخوف من وقوع الضرر بسب الإخلال بالوعد:
هذه إحدى الحج التي يذكرها القائلون بالإلزام بالوعد، وتوجيههم لذلك؛ أنّ الوعد إذا جعل على الخيار تساهلَ الناس في الوفاء به؛ لضعف الدين، وقلة الأمانة، والإخلال به ينتج عنه أحيانًا ضرر فادح، حيث يشتري المصرف السلعة بمئات الملايين، وإذا تركها الواعد بالشراءِ، لا يجد المصرف لها سوقًا، فَيُعَرِّض أموال الناس إلى التلف، وهذا من الضرر البين الذي يجب رفعه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا ضرر ولا ضرار) ، وكذلك فإن من القواعد الفقهية الكلية المتفق عليها؛ أنّ الضرر يزال.
لكن ينبغي قبل التسليم بهذه الدعوى والحكم لها أو عليها؛ عرضُها على واقع المصارف الإسلاميةِ، التي لم تأخذ بالإلزام بالوعد على مدى العشرين أو الثلاثين سنة الماضية، فينظر: هل ترتب على ما تعطيه من خيار في الوعد مدة هذه السنين الطويلة ضرر فعلي حقيقي، عَرّضَ أموال المستثمرين إلى الضياعِ، بسبب سوء المعاملة، وشيوع الخلف في الوعد غير الملزم؟ أم أنّ هذا الضرر المتخوف منه هو افتراضٌ لا وجود له في واقع المعاملات اليومية، على مرّ هذه السنين؟
الذي أعلمه أنه لا وجود لهذا الضرر المفترض في المصارف التي لا تأخذ بالإلزام، على مرّ هذه السنين، وإلا لو كان هناك ضررٌ حقيقي متكرر من الممارسات اليومية للوعودِ غير الملزمة، التي تعقد مع هذه المصارف؛ لمَا استمرت هذه المصارف على العمل بها، ولتوقفت على الفور، وبحثت عن بديلٍ؛ لأنه لا يُعقل أن تتكرر خسائرها بسبب الخلف بالوعد وتستمر عليه؛ معرضةً أموالَها للضياع.
فَتَوَقُّع الضرر هو شيء نظري افتراضي، لا يؤيده الواقع، وبذلك يصعب التعويل عليه لمخالفة حكم، هو محل اتفاق عند المتقدمين، وأصله ثابتٌ في السنة، وظاهر في دلائلها، ظهورًا لا خفاء فيه، وليس كلام المالكية وابن شبرمة وعطاء في وجوب الوفاء بالوعد قادحًا في هذا الاتفاق؛ لأنهما مسألتان مختلفتان، غير واردتين على محل واحد؛ كما تقدم تفصيله عند توضيح مذهب المالكية.
ثم إنه يمكن التحرز من هذا الضررِ المتوقع بوجوه متعددةٍ، دون ارتكاب مخالفة.
منها؛ شراءُ البائع على الخيار فيما يمكنه شراؤه على الخيار، على ما ذكره محمد بن الحسن الشيباني وابن القيم.
ومنها؛ تحرز المصارف بألّا تلبي طلبات الأمر بالشراء إلا لمن ثبت لديها أمانته وعدالته، وصحة تعامله، وذلك من خلال التحريات، وما تجمعه عنه قبل الموافقة مِن معلومات وتقارير عن سيرته وسلوكه ومعاملاته السابقة، مع المصارف وغيرها، وكذلك عن طريق عدد من الجهات التي سبق له التعامل معها بعقود، أيًّا كان نوعها، ولو مع المؤجرين له والمستأجرينَ منه؛ لمعرفة مدَى دقته وانضباطه ووفائه، والتزامه بالعقود.
ومنها؛ أنه ليس واجبا على المصرف أن يشتري كل سلعة أمره راغب بشرائها ليشتريَها منه، فعليه أن يدرس السوقَ، كأيّ تاجر محترف، ولا يُقْدم على شراء الصفقات التي لا يطلبها السوق، إلا إذا وثق في ذمة العميل الذي وعدَ بالشراء ووفائه، فهذه وغيرها من وجوه التحوط إذا أخذها المصرف في حسابه وعمل بها؛ لا يبقى معها للضرر المفترض أثرٌ، والذي هو أساسًا - مِن خلالِ التعامل الفعليّ - نادرٌ أو منتفٍ، لا وجود لهُ على مرِّ السنين، والله تعالى أعلمُ وأحكمُ.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
الخميس 19 شعبان 1436 هـ
الموافق 26 مايو 2016 م.