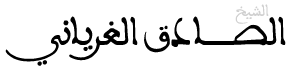بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحيمِ
(وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ)
الآيةُ، وإن كان سِياقُها في القتالِ، وأنه فُرِضَ على المسلمين وهو كُرهٌ لهم، تُحمَلُ عليه النفوسُ حملًا؛ فإنّها -أي الآية - تشريعٌ شاملٌ مُحكَمٌ في تَهيِئة النفوسِ لقانونِ الابتلاءِ، الذي لا يخلُو منهُ أمرٌ ذو بالٍ في حياةِ الناسِ، وبِتهيئةِ النفوسِ له وقَبولِه، والتعامُلِ معه على الوجهِ الذِي شرعَه اللهُ، تنصلِحُ للناسِ الدنيا، وتنقادُ نوامِيسُ الحياةِ، وتَحسُنُ للمسلمِ أيضًا العُقبَى، فيتأهلُ للفوزِ بها، إذْ بتصبيرِ النفسِ عند وقوعِ الابتلاء، وبتَأميلِها أن ينقلبَ خيرًا عند انفراجهِ؛ تتحولُ المحنَةُ مع الصبرِ إلى مِنحةٍ، فكم مِن مرةٍ ظنَّ العدوُّ أنّ قصفَ المدنِ بالطائراتِ يطعن الثورة في مقتل يوصِلُه إلى مُرادِه، ويُصيبُها بالإحباطِ واليأسِ، فانعكَس عليهِ الأمرُ، وقلب له ثوارُ الجبهات ظهر المِـِجن، فاجتمعَ عليهِ المتفرّقُ، وزادت ضراوة الجبهة عليه، فوقعَ في شرِّ فعلِه، ومُنِيَ بهزيمةٍ نكراء؛ (وَعَسَى أَنْ تكْرَهُوا شيئًا وهوَ خيرٌ لَكُم).
ويتمَهّدُ مِن معاني هذه الآيةِ الكريمةِ، في السياق الذي جاءَت فيهِ، قواعدُ، منها:
1- القتالُ الذي فرضَه اللهُ لا يكونُ إلّا لِإعلاءِ كلمةِ اللهِ، لا للحمِيَّة، ولا للقبيلةِ، والجهوية، ولا للشجاعةِ والشهرة، ولا للغنيمةِ، إلّا أن تكونَ تَبَعًا، لا مقصودَةً ابتدَاءً بالخروج.
والقوات التي كلفتها رئاسة الأركان، التابعة للمؤتمر الوطني العام - بحمد الله - سواء في جبل نفوسة، أو التي توجهت إلى ميناء السدرة لتحريره ، لم تخرج باسم جهة ولا قبيلة، ولا شرق وغرب، كما يصوره الإعلام المضلل، بل خرجت لأجل تخليص ليبيا من العودة إلى الاستبداد والقهر، وتخليص ثروتها النفطية وموانئها، لتعود لليبين جميعا، يتمتعون بخيراتها، لا فرق بين شرق وغرب، بعد تسلط غاشم عليها دام طويلا من عصابات الجضران، التي ضُبطت في عُرض البحر، تحاول تهريبه لإسرائيل، وكلفت تسلطها عليه خسارة عشرات المليارات، فمعركة النفط يا أهلنا في الشرق ليست موجهة ضد الشرق، بل لتمكينكم والليبيين جميعا من حقوقكم المسلوبة.
2- فَرَضَ اللهُ القتالَ وهوَ كُرْهٌ، والكُرهُ هو الشاقُّ الشديدُ على النفسِ، ووُصِفَ بذلكَ لِما فيه مِن تعريضِ النفسِ للهلاكِ، وأَلمِ الجراحِ، وعدمِ الراحةِ، بمفارقة الأهلِ، وانشغالِ البالِ، والتوتر الدائم بالليل والنهار، ناهيك إذا كان مع هذا كله قلة زاد وعتاد.
3- كُرْهُ القتالِ هو مِن الإحساسِ المغرُوزِ في الطبعِ، لا أحدَ يقدرُ على دفعِه عن نفسِه، يشتركُ فيه الشجاعُ والجبانُ، والضعيفُ والقويُّ، ولكن لا يتحمَّله - على كُرهِ النفسِ له -ويقومُ بأعبائِه مِن النّاسِ، دفاعا عن الحق، إلّا ذَوُو النّفوسِ الكبيرةِ، والهِممِ الرفيعة، والأقدارِ العالية؛ لِما يحققُهُ الصبرُ عليه مِن غاياتٍ عظيمةِ القدر، جليلة الشأنِ، عزيزةِ المطلبِ، تَربُو مصالحُها ومقاصدُهَا ومَنافِعُها للأمةِ على مَا يُصيبُ النفوسَ مِن آلامِه وأوجاعِه، وأضرارِهِ وأحزانِهِ، والسلوى في ذلك للمسلم ما أعدَّ الله تعالى لِمن قُتلَ في سبيلِه مِنَ المنزلَةِ، حتّى إنّه يتمنَّى أن يرجعَ إلى الدنيا فيُقتَلَ، ثمّ يرجِعَ فيقتلَ، ثم يرجعَ فيُقتلَ، وليسَ ذلك إلا للشهِيدِ، لما يرى من الكرامة.
4- لا يتنافَى كُره النفوسِ في الطبعِ للقتالِ، مع مَا وعدَ اللهُ تعالى بهِ مِن الجنةِ، وما رتّبَ عليه مِن الأجورِ لمن يقاتلُ في سبيلِه، لإعلاءِ كلمتِه، مقبلًا غيرَ مدبرٍ؛ لأنّ تحمُّل القيامِ بما تكرهُهُ النفسُ، مرضاةً لله تعالَى، هو عينُ الصبرِ على الابتلاءِ، الذي جزاؤُه الجنةُ، قال تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ).
5- رفقًا بالعبادِ، بعدَ أن فَرض اللهُ عليهمُ القتالَ، وهم يكرَهُونه، قال لهم ليهوّنه عليهم: (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ)، تلطّفًا منه ورحمة، واللهُ تبارك وتعالى غنيٌّ، لا يحتاجُ إلى إرضاءِ أحدٍ، يأمرُ فيٌطاعُ، لكن مِن أسمائِه سبحانَه (اللطيف)، يتلطفُ بعبادِه، حتى يُبَيّن لهم الحِكَمَ والغاياتِ من شَرَعَه؛ تفضلًا منهُ ومِنَّةً؛ لِما في ذلك مِن المصالِحِ العظيمة الجليلة، الراجِعَة إلَى المكلَّفينَ، فتزدادُ ببيانِها رَغبتُهم في الخيرِ، وعزيمتهم على الطاعة، وإقبالهم طواعية على أوامِرِ الله، وحرصهم على التمسكِ بها، وهذا مِن مَحاسنِ تشريعِ الإسلام، الذي أُحكِمَت آياتُ كتابِه، ثمّ فُصلَت مِن لَدُنْ حَكيمٍ خبيرٍ.
6- بَيَّنَ سبحانهُ بالنص القاطع أنّه قد يجعلُ عاقبَةَ ما تكرهُهُ النفوسُ خيرًا، وعاقبَةَ ما تحِبّهُ شراً؛ لأنَّ العبرةَ في كلِّ ما يفعلُه العقلاءُ، إنّما هيَ بالغاياتِ والخواتيم، فهي التِي يحرصُ عليها أولُو الألبابِ، ومَن آتاهُ اللهُ حكما وعلمًا.
فتحمُّل مرارةِ الدواءِ عاقِبتُها العافيةُ، وتَرْكُ طالب العلمِ لذيذَ الراحَةِ وطِيبَ المنامِ ومُنادَمَةَ الأصحابِ، مع المعاناة الشديدة لقسوة الحياة، وشظف العيش، والرضى بالقليل، بغية الانقطاعِ للتحصيلِ، وثَنْيِ الرّكب في مزاحمَةِ الأقرانِ، ومداوَمَة الدرسِ - عاقبتُهُ التميّزُ بينَ الأصحابِ، وعلو الكعب في التشرُّفُ بشرف العلمِ، الذي به للمرأ - إن عمل - بلوغُ المجد، ورفعةُ القدرِ، وعلوُّ الشأنِ، وغايته نفعُ المسلمينَ، وهداية الخلق، فتزداد الحاجةُ إلى العالِم، ومحبّة الخلق له.
7- مكابَدةُ مشاقِّ الطاعاتِ، والصبرُ عليها بمخالفَةِ هوَى النفسِ، عاقبتُه مرضاةُ اللهِ تعالَى والجنةُ، وهكذا سائرُ التكاليفِ، كلّها على خِلافِ ميلِ النفوسِ، وفيها فلاحُها.
وما تَهواهُ الطباعُ على خلافِ الشرع، كلُّه محبوبٌ، وفيهِ هلاكها، وإليه الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ).
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
الإثنين 14 ربيع الأول 1436هـ
الموافق 5 يناير 2015 م